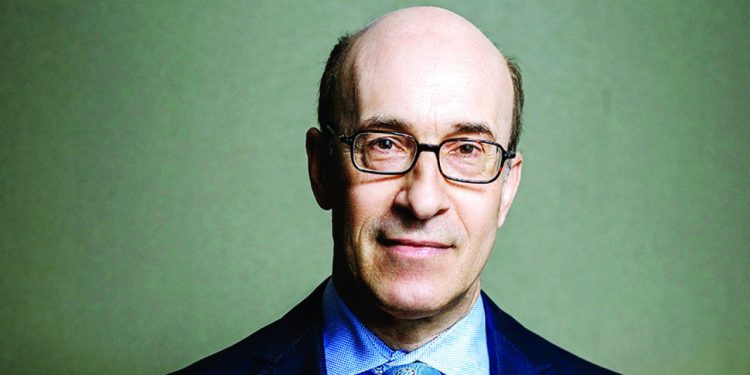في عام 2014، أحدث كتاب نُـشِـر لرجل الاقتصاد الفرنسي توماس بيكيتي بعنوان “رأس المال في القرن الحادي والعشرين” ضجة دولية، حيث أعاد تشكيل الحوار الدائر حول التفاوت وقَـذَفَ بمؤلفه إلى عالم النجومية.
كان بيكيتي مُـحِـقا في الإشارة إلى أن الحجة السياسية لصالح إعادة توزيع الدخل تركز بالكامل تقريبا على المخاوف المحلية. لكن حجته المركزية- ومفادها أن الرأسمالية تُـفضي حتما إلى فجوة تفاوت متزايدة الاتساع- تنهار عند مقارنة وضع المزارعين الفقراء في فيتنام بالراحة النسبية التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون المنتمون إلى الطبقة المتوسطة.
في حقيقة الأمر، أدى صعود الاقتصادات المدفوع بالتجارة في آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية على مدار العقود الأربعة الأخيرة، إلى ما قد يكون الانخفاض الأكبر على الإطلاق في التفاوت بين البلدان في تاريخ البشرية.
رغم هذا، نادرا ما يفعل المراقبون الغربيون أكثر من مجرد التشدق بأحوال نحو 85% من سكان العالم الذين يعيشون في الجنوب العالمي.
وفي حين يكرس مُـحِـبو الخير من أمثال بِيل جيتس قدرا كبيرا من الموارد لتحسين الحياة في أفريقيا، فإن أغلب المؤسسات والجمعيات الخيرية تظل على تركيزها على تضييق فجوات التفاوت داخل البلدان.
ورغم أن القضيتين جديرتان بالإعجاب، فإن المحللين السياسيين يتجاهلون غالبا حقيقة مفادها أن الفقر، وفقا للمعايير العالمية، لا وجود له تقريبا في الاقتصادات المتقدمة.
بطبيعة الحال، ليس للمزارعين في الهند أي تأثير على الانتخابات الأمريكية أو الأوروبية، حيث تحول التركيز على نحو متزايد إلى الداخل في الأعوام الأخيرة. فاليوم، لا يفوز المرشحون بالتعهد بمساعدة أفريقيا، ناهيك عن جنوب آسيا أو أمريكا الجنوبية.
وهذا التحول يساعد في تفسير السبب وراء الصدى القوي الذي خلفه تأطير بيكيتي للتفاوت باعتباره قضية محلية بين التقدميين الأمريكيين، وبشكل غير مباشر مع حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن هذا التفسير يتجاهل مئات الملايين من البشر الذين يعيشون في البلدان النامية المعرضة لمخاطر تغير المناخ.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من التأثير الدائم الذي خلفه الاستعمار، لن نجد رغبة كبيرة من جانب دول الرفاهة الاجتماعية في أوروبا أو اليابان لدفع تعويضات للمستعمرات السابقة.
لا شك أن الحجة قوية لصالح تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في البلدان المتقدمة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعليم والرعاية الصحية.
ولكن من منظور أخلاقي، يظل من المثير للجدال إلى حد كبير ما إذا كان هذا يفوق الحاجة الملحة لمعالجة محنة 700 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم يعيشون في فقر مدقع.
يُـنـسَـب إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الفضل في اتخاذ خطوات كبيرة لمساعدة البلدان النامية. لكن مواردهما وتفويضاتهما تظل محدودة، وتميل البلدان الغنية إلى دعم السياسات والمبادرات التي تتوافق مع مصالحها الخاصة.
تُـعَـد الحاجة إلى العمل المناخي من المجالات التي يبدو أنها تحظى بإجماع واسع النطاق.
وعلى هذا فقد دأبتُ لفترة طويلة على الدعوة إلى إنشاء بنك عالمي للكربون يدعم التحول الأخضر في البلدان النامية من خلال تقديم المساعدة الفنية وعرض التمويل على نطاق ضخم للعمل المناخي، ومن الأفضل أن يكون ذلك من خلال المنح، وليس القروض.
وكما زعمت مؤخرا، فإن تمويل المنح مهم بشكل خاص في ضوء طريقة حاسمة أخرى لإصلاح الرأسمالية العالمية: منع المقرضين من القطاع الخاص من مقاضاة المدينين السياديين المتخلفين عن السداد في محاكم البلدان المتقدمة.
لكي يتسنى لها اجتذاب التمويل الخاص، يتعين على البلدان النامية بناء محاكم ومؤسسات أخرى جديرة بالمصداقية على أرضها. وإلى أن تفعل ذلك، سوف يكون من الضروري سد فجوة التمويل.
في نهاية المطاف، يتطلب الحد من الفقر العالمي قدرا أعظم من الانفتاح وحواجز تجارية أقل.
ويشكل تفتت الاقتصاد العالمي، الذي تغذيه التوترات الجيوسياسية والسياسيون الشعبويون الذين يدفعون باتجاه فرض قيود تجارية، تهديدا خطيرا للآفاق الاقتصادية في أفقر بلدان العالم.
ويتصاعد خطر تأثير انعدام الاستقرار السياسي في هذه المناطق على البلدان الأكثر ثراء بوتيرة مثيرة للقلق، وهو ما ينعكس بالفعل في المناقشات المتزايدة التوتر في هذه البلدان حول الهجرة.
الواقع أن الاقتصادات المتقدمة أمامها ثلاثة خيارات، ولا يركز أي منها بشكل منفرد على التفاوت المحلي.
فأولا، يمكنها تعزيز قدرتها على إدارة ضغوط الهجرة والتصدي للأنظمة التي تسعى إلى زعزعة استقرار النظام العالمي.
ثانيا، بوسعها أن تزيد الدعم الذي تقدمه للدول المنخفضة الدخل، وخاصة تلك القادرة على تجنب الحرب الأهلية.
أخيرا، تستطيع إرسال مواطنين لمساعدة الدول المنخفضة الدخل. وقد جربت حكومات عديدة بالفعل مع برامج محلية تشجع خريجي الكليات الجدد على قضاء عام في التدريس أو بناء المساكن في المجتمعات المحرومة.
في أقل تقدير، يساعد إرسال طلاب غربيين إلى البلدان النامية- ولو لفترات قصيرة- في تمكين الناشطين المتميزين في الحرم الجامعي من التعرف على الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها قسم كبير من سكان العالم وأن يروا بأنفسهم كيف يعيش الناس في البلدان حيث لم تترسخ الرأسمالية بعد.
مثل هذه التجارب من الممكن أن تعمل على تعزيز وعي أعمق بالتحديات العالمية ومنح الشباب فهم أكثر وضوحا للأزمات التي قد تؤثر في نهاية المطاف على حياتهم شخصيا.
لا يعني هذا أن فجوات التفاوت داخل البلدان ليست قضية خطيرة. لكنها لا تشكل التهديد الأعظم للاستدامة والرفاهة البشرية. بل تتمثل المهمة الأكثر إلحاحا في مواجهة الزعماء الغربيين في إيجاد الإرادة السياسية اللازمة لتمكين البلدان من الوصول إلى الأسواق العالمية وجلب مواطنيها إلى القرن الحادي والعشرين.
بقلم: كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد
المصدر: موقع “بروجكت سنديكيت”